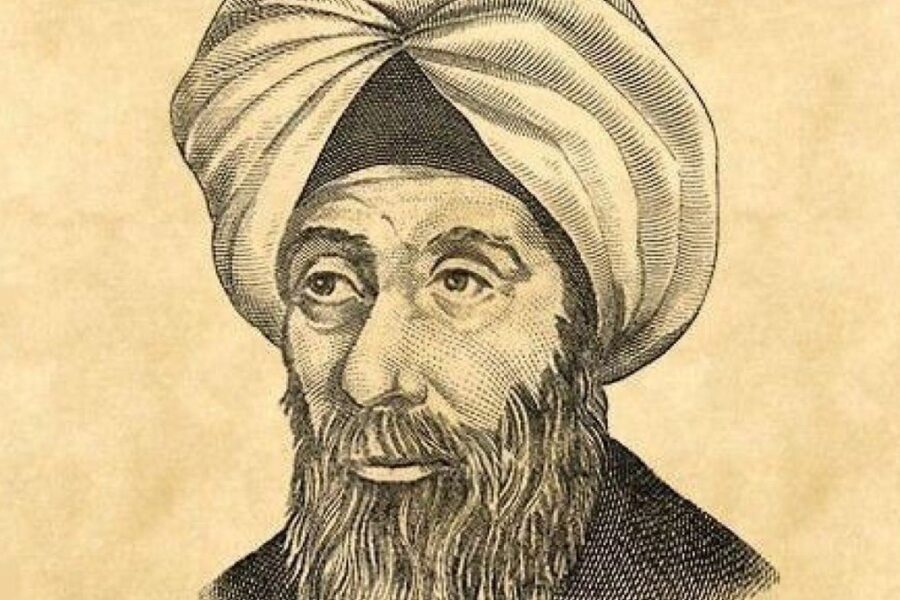سبحان الحي الذي لا يموت. وما الموت إذن؟ سؤال فيه من البداهة والوضوح نفس الذي فيه من الغموض. هو السؤال الذي حيّر البشرية وأرهق عقول الفلاسفة والمفكرين، إذ كيف يمكن للحي أن يعرف شيئاً عن الموت وهو لم يختبره ولا يمكن أن يختبره ما دام حياً. وحتى الاقتراب الشديد من الموت لا يعطينا شيئاً عنه، بل غالباً ما يجعلنا نفهم الحياة أكثر من ذي قبل، فالموت كما نعيه وندركه بشكل عقلاني محض، ما هو إلا عملية انتقال كلي من مستوى ما في الوجود إلى مستوى آخر مختلف عنه في كل شيء، هو مكان لن يبلغه أحد منا إلا بالخروج نهائياً من الحياة، خروج لا عودة بعده بالمطلق.
سبحان الحي الذي لا يموت… مالي أكرر هذه العبارة، فأسمعها من خلال صوتي المختنق داخل غصتي كأنني أسمعها للمرة الأولى؟ ألأنني بتُّ أفهمها اليوم وقد توضح لي معناها كما لم يتوضح من قبل؟
بحان الحي الذي لا يموت… وما زلت أكرر العبارة ذاتها منذ أن مات أبي صباح السبت الماضي تاركاً كل هذا الفراغ الذي أشعره كأنما يملأ الدنيا من أقصى مشرقها إلى أقصى مغربها، وتاركاً أيضاً ولده حسن يتيماً كأنه لم يكبر أبداً ولم يبلغ الرشد بعد، وأيّ رشد هذا الذي يمكن أن أتقوى به أمام فاجعة كهذه؟ مات أبي فسبحان الذي لا يموت، رب الحياة ورب الموت، ومالك الدنيا والآخرة، له ما أعطى وله ما أخذ، وليس لنا في الأمر أمامه من شيء.
مات أبي بعدما غالب المرض بضع سنوات حتى غلبه، فكانت هذه السنوات هي الأقسى عليّ وأنا أرى من أحب يتألم وتذهب عنه قوة الحياة شيئاً فشيئاً، وأنا أمامه عاجز لا يعزّيني في ألمه شيء، وقد بلغ بي القهر منتهاه فلا أستطيع ردّ المرض عنه، وعرفت كيف أنه لا يمكننا تجاوز ألم من نحب كما نتجاوز ألمنا ذاته.
سبحان قاهر عباده بالموت، وقد كنت أظن في ما سبق أن القهر هنا يقع على الميت نفسه، فلما مات أبي عرفت أن الحيّ هو المقهور أمام خسارة لا يعوضها مال ولا مكانة ولا أي إنجاز مهما بلغ شأنه.
مات أبي في يوم مولدي ذاته، ليصبح رحيله عبرة لي ستبقى كلما صادفتُ ذكرى هذا اليوم، إذ تجتمع مناسبة الولادة مع مناسبة الوفاة كوجهين متضادين لحقيقة الحياة بكل ما فيها من تغير وتبدل واجتماع للأحوال. ورغم إيماني بقضاء الله وقدره، وتسليمي بما يمضي من مشيئته، والتزامي بقول ما يرضي الحق سبحانه، إلا أن الفقد يبقى هو هو، كأس مرّة أتجرعها فتكون فوق طاقتي وفوق احتمالي، كيف لا وقد خسرت الرجل الأحب إلى قلبي، وغاب عني نموذج الإنسان القوي الذي لم يعرف اليأس أو الهزيمة يوماً، وبقي لآخر ساعة راسخاً كجبل عظيم لم أرَ فيه ضعفاً رغم أنه قضى آخر حياته جليس المقعد بعدما بترت ساقه بسبب مرض السكر، فقعد جسده وأبت روحه إلا أن تبقى واقفة وشامخة إلى اللحظة الأخيرة.
ويلي من ذكرى اللحظة الأخيرة كيف انحفرت في خيالي ولن تزول، حين اسودّت الدنيا أمامي وتمنيت لو أن الأرض تنشق وتبتلعني كي لا أرى ما رأيت، وكي لا ينفطر قلبي على حبيبي وعلى شعلة النور التي أنارت لي طريق المحبة والسلام ومعاملة الناس بالحسنى حتى لو أساءوا وأخطأوا، فالروح العظيمة وعاء لا ينضح إلا بما فيه، وقد كان أبي من أصحاب هذي الروح التي لا تبادي الناس إلا بالصفح والكرم والمساعدة والسير بالمعروف بين الجميع.
مات أبي الذي اختبر تقلّب الحياة من كل جهاتها، وأمضى عمره مكافحاً ومحارباً نبيلاً وافر العاطفة شديد الحنان كأنما قُدّت كتفاه من صخر وقُدّ قلبه من ندى، والله إن كل المواقف التي اختلفت فيها معه أيام صباي، واختار فيها الحزم والقسوة معي، لم تنقص من محبتي له وتعلق قلبي به. حتى لما بلغت مبلغ الكبار كبرت في كل شيء إلا في أن أبقى صغيره الذي ما زال يُسر بعطف الأب وحنانه في صورتهما الأولى.
مات أبي مطمئناً راضياً بقدر الله وتدبيره، مات بعيداً من قلقيليا مسقط رأسه، والتي نزح منها عام 1967 ماشياً على قدميه قاصداً الأردن، ليكمل تعليمه ويتخرج في الجامعة/ قسم اللغة العربية، ويسافر إلى اليمن ثم ليبيا، ثم إلى السعودية التي عمل ومكث فيها طويلاً، فعاش حياته قوي الشكيمة ذا همة ومروءة، مداوماً على عمله، شديد البأس معه نفسه، حازماً مع أولاده حتى كنت أظن أن القساوة من طبعه، فلما كبرت أدركت أن قساوته معي لم تكن سوى شفيع القدوة التي أراد أن أقتديها به، والتي صنعت مني ما أنا عليه اليوم من نجاح وقدرة على مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. ثم بدأ يتكشف لي المخفي عني من طباعه وما كان يتصف به من رقة في القلب وسعة في الصدر دفعتاه إلى أن لا يتأخر عن المساعدة وجبر الخواطر وإصلاح ذات البين بكل ما أمكنه واستطاع إليه من سُبُل.
سبحان الحي الذي لا يموت… سبحان الذي لا يصيبه فقد ولا تعب، وأنا الفقير إليه وقد مررت في حياتي بالصعاب وتجرعت مرّ الخسارة وعانيت قساوة العيش ومعاندته، لكن لحظة فقد أبي أنستني كل ما مضى وأذاقتني مرارة خسارة لم أشعر بها من قبل، ورغم رغبتي الشديدة في التعبير عنها، إلا أني أشعر بأن لا كلمات يمكن أن تعبر عن حقيقة هذا الشعور ومقداره، وأن لا سبيل للبوح مهما قلت ومهما حاولت. كان بكائي ساعة موته شديداً، وكان ضعفي كبيراً لم أكن أتخيل أن ينتابني لحظة سلّمته يداي للقبر كأنما سلّمت روحي لتُدفن بجانبه، وكان عقلي معطلاً إلا من التفكر في عبثية الحياة وسقوط قيمتها في عينيّ.
مات والدي فلا عزاء لي إلا في اثنتين: الأولى أنه بجوار رب كريم غفور رحيم هو خير من الدنيا وما فيها، أما الثانية فأنه عاش راضياً عن حياته رغم صعابها، وقد انتهت عنده كما كان يحب ويرضى، وحقق ما أراد تحقيقه قبل أن يغادرنا، فقد كان راغباً في أن يؤسس لأهل بلدته مجلساً يضم صغيرهم وكبيرهم، ويكون مكاناً لاجتماعهم في أفراحهم وأحزانهم وبقية مناسباتهم، وقد وفقه الله بذلك فاشترى الأرض وأقام البناء وأطلق عليه اسم مجلس قلقيليا. وكأنما أراد أن تستمر عادته بعد موته، فقد كان رحمه الله ذا مكانة اجتماعية بين أهل بلدته، لا يتأخر عنهم في أمر ولا تفتقده مناسباتهم ومجالسهم. وكان في الوقت ذاته محبّاً للاعتكاف يغلب عليه الزهد، ملتزماً بصلاة المسجد ومداوماً على قراءة القرآن الذي جعله دستور حياتنا منذ صغرنا، ولذلك كان حريصاً أن يدخلني مدارس تحفيظ القرآن الكريم في السعودية يوم كنت طالباً في المرحلة الابتدائية.
ولقد أكرمني الله بنعمة عظيمة حين استطعت استقدام والدي ليعيش معي في سنواته الأخيرة حيث أعيش، فكانت تلك الصحبة بيننا من أجمل ما في حياتي، وأنا أراه وقد كبر وصار شيخاً تطوف بركته على بيتي وأهلي وأولادي، وأقضي معه ساعات نتبادل فيها ذكريات طفولتي وشبابه، فأقص عليه ما كنت أفعل في صباي وما كان يفعل هو معي، فيزجرني حين يغضب، وينهاني حين أخطئ، ويهددني بالعقوبة ولا ينفذها، كنت ألاطفه وأذكره بكل ذلك فيضحك مبتسماً على أيام مضت. أما الآن فقد مضت ذكريات الأيام ومضى أصحابها، فامنحني يا رب القوة لأصبر على ما قضيت وما أمضيت.
أعرف أن الموت حق… وأنه قدرنا جميعاً، وقد عودت نفسي وفكري على التسليم بأنه جزء الحياة الذي لا بد منه، فأين ذهبت كل تلك القناعة وذلك التسليم لما شهدت لحظات أبي الأخيرة ورأيته يسلم الروح لباريها؟ لقد كانت لحظة لا تُنسى أبداً ولا أظن ألمها وقهرها سيفارقان ذاكرتي ما حييت، إذ ليس هناك ما هو أقسى من الأبد… وقد افترقنا اليوم إلى أبد هذه الحياة. ولما بكيت أشد ما يكون البكاء أدركت بعد نفاذ أمر الله أن البكاء ليس رد فعل أمام الموت، بل هو الفعل الذي لا أستطيع القيام بغيره أمام كل هذا الشعور بالعجز والقهر.
أدركت الآن أنه رغم الإغلاق الفكري الشديد الذي يكتنف حالة الموت، ثمة تجربة واحدة تجعلنا على أقرب مسافة منه، هي هذه، هي حالة الفقد التي لا تكون فيها أنت الميت، بل الميت هو أصلك وسبب حياتك، والذي يمثل وجوده جزءاً أصيلاً من وجودك أنت، وهذا ما يجعلك تشعر بأن جزءاً منك قد مات بموت هذا الأصل. ورغم شدة الحزن الذي يرافق هذا الشعور، إلا أن الحداد أشد منه، وفيه يكون ترتيب حياتك من جديد وأنت تحاول سدّ خسارة فيها ونقص أصابها لا يمكن تعويضه بالمطلق.
بعد أن أودعت أمانة الله في القبر… وصار الزمن ثقيلاً جاثماً بين ساعة ميلادي وساعة موت أبي، مرت الذكريات دفعة واحدة في بضع ثوانٍ كأنها الدهر نفسه، لتقترن فيها الحياة بالموت، ويجتمع الضدان في الموقف ذاته على ضفتين متقابلتين، فهل هذا ما قصده الفلاسفة حين حاولوا أنسنة التفكير في الموت، هل هذا ما وجده هيراقليطس عندما قال إن الموت كامن فينا وبداخلنا ونحن أحياء؟ وهل قال قولته هذه عن تجربة فقد أيضاً؟ أم كانت لحظة تأمل وتفكر مجرد من كل حزن؟ وهل هذا الموقف هو ما أوصل هيدغر ليقول إننا خلقنا لنموت… وإن الموت أصيل في كينونتنا؟ ثم اجتاحني سؤال أخير: هل حقاً في الفلسفة عزاء عن كل هذا الألم وهذا الحزن؟
إن القلب ليحزن… وإن العين لتدمع… ولا أقول إلا ما يرضي الله: فيا رب ارحم عبدالله إسميك.. عبدك وضيفك ووليك، أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وارزقه جوارك الكريم في علييّن، اللّهم لا تحرمني أجره، وعوضني عن دعائه لي أيام حياته، ذلك الدعاء الذي كان نبراس نور وقوة جعلاني دائماً قادراً على مواجهة الصعاب وتحمل المشقات… اللّهم آمين، آمين، آمين.