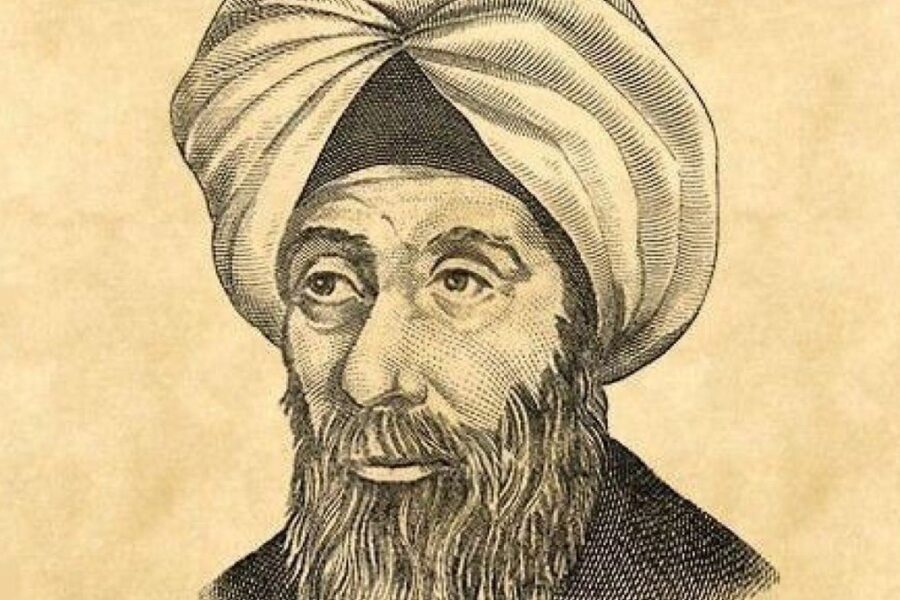“حسن اسميك”
تعددت الآراء وتباينت التأويلات في تحديد أصل تسمية مصر «أم الدنيا» فبينما ذهب البعض إلى أن الرومان أطلقوا على مصر اسم «أم الدنيا» لأنها كانت المصدر الأساس لتزويد الإمبراطورية الرومانية بالطعام والقمح؛ يذهب البعض الآخر لتفسير أصل هذه التسمية نسبة للسيدة هاجر، زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكانت من مصر لما تزوجها إبراهيم ثم انتقل معها إلى الجزيرة العربية، ليرفع نبي الله قواعد البيت العتيق، فكانت التسمية تكريماً للسيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل. وأضيف إلى ذلك ما قاله الرحالة ابن بطوطة في كتابه (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): «ثم وصلت مصر وهي»أم البلاد«وقرارة فرعون ذي الأوتاد، ذات الأقاليم العريضة، والبلاد الأريضة المتناهية في كثرة العمارة، المتناهية بالحسن والنظارة.. قهرت قاهرتها الأمم، وتمكنت ملوكها نواصي العرب والعجم». بينما يُعيد البعض الآخر هذه التسمية إلى ان مصر هي أوّل حضارة عرف أهلها الكتابة والتدوين؛ لذلك كانت أول دولة في العالم تمتلك تاريخاً مكتوباً في سجلات تروي الأحداث التي مرت بها هذه الدولة، ولهذا السبب سُمّيت بـ «أم الدنيا».
وبالرغم من صعوبة تقصي أصل التسمية بـ «أم الدنيا»، يبدو التحقق من صحته أيسر ما يكون، فمصر التي حملت من الأسرار ما أدهش العالم وأثبت تفوقها في كل عصر، لم تكفَّ يوماً عن كونها مركز تأثير يشد أنظار الدنيا إليه، مهما تعرَّضت للتقلبات ومهما حملت من تناقضات، فكان لها دورٌ بارزٌ في جميع المراحل التاريخية، وطبعت الحضارات التي مرت عليها بطابعها المصري مثلما تأثرت هي بسمات تلك الحضارات، فكان خلاصة ذلك كله جمال يتجاوز الجمال إلى مستويات من السحر والجاذبية الأخاذة والمفاجئة وحتى الصادمة.
ففي مصر وحدها تسمع عن جسد محنط منذ أربعة آلاف سنة، كما أن شق قناة السويس فيها كان كفيلاً بتغيير جيوبوليتيك العالم وخارطة مواصلاته واتصاله، وكذلك في مصر وحدها يستطيع شخص أمّي أن يفتتح مكتبة تتحول إلى مركز ثقافي يساند الجامعات والباحثين بمختلف اختصاصاتهم العلمية. أطلق ذلك الشخص اسمه على مكتبته فكانت «مكتبة الحاج مدبولي»، ولقد كان مخلصاً لروحه المصرية الفريدة والمدنية، واشتهر بليبراليته، فلم يتوانَ عن بيع كافة أنواع الكتب حتى تلك التي تناقش الخطاب الديني وتنقده في أحيانٍ كثيرة.
ولأن مصر توقعك بكل تفاصيلها فريسة للفضول، حملني فضولي إلى تلك المكتبة بقصد اكتشافها، متوقعاً صورة شعبية، قديمة، غنية بالمعنى فقيرة بالشكل، إلا أن ما وجدته كان مختلفاً، فالمكان الذي لا يمكن نزع الصفة الشعبية عنه كان مرتباً بطريقة رائعة، ومقسماً إلى أركان مخصصة، كل فئة من الكتب على حدة، تحظى فيه الكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه باهتمام مناسب، ومثلها المخطوطات والكتب القديمة غير المحققة، بشكل يصل القديم بالحديث، ويخلط الفقر بالغنى، وكأن صاحبها قد جمع تاريخ مصر وحاضرها وعرضهما بين رفوف كتبه.
لم تكن مكتبة «مدبولي» طفرة إنما كانت قطرةً من سيل تاريخ مصر المعرفي، والذي لم يتوقف يوماً عن رفد الإنسانية، كيف لا وفي مصر أقدم مكتبة عامة عرفها التاريخ؛ «مكتبة الإسكندرية»، التي شيدها بطليموس الأول، وكانت أكبر مكتبات عصرها وأغناها، إذ احتوت مئات آلاف المجلدات من المخطوطات والكتب، الإغريقية منها والفرعونية، وبذلك صنعت مزيجاً من علوم هاتين الحضارتين، حتى أصبحت معروفة باسم «المكتبة العظمى». قبل أن ينتهي بها المطاف حرقاً على يد يوليوس قيصر.
وفي حين ذهب بعض المؤرخين إلى أن مكتبة الإسكندرية انتهت عن آخرها في حريق عام 48 ق.م، رأى آخرون أنها عادت للحياة وتعرضت لحرائق وإيذاءات عديدة كان آخرها عام 642 م، وبين نفي المؤرخين وتأييدهم لصحة هذه الأخبار، يشيح التاريخ بناظريه عنها ويلتفت إلى القاهرة حيث دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي لتضم بين رفوفها مليوناً وستمئة ألف كتاب متاحة مجاناً لعامة الشعب، نُقل نصفها إلى أروقة الأزهر فيما بعد.
يكاد يبدو لك أن وجود مكتبة رئيسية تشكل صرحاً ثقافياً قدرٌ محتومٌ لمصر لا تستطيع التملص منه ولو أرادت، وهذا ما كان في أوائل عصر النهضة العربية، حيث برزت مكتبة الأزهر الشريف بإيعاز من الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، نتيجة مخزون الأزهر الضخم من الكتب والمخطوطات، والتي احتضنها منذ العصر الفاطمي. برزت هذه المكتبة أيضاً كمركز إشعاع فكري، يثبت أن الإنسان العربي عنصر متجذر في التاريخ، قادر على الاستناد إلى حقائق تاريخه للنهوض من جديد، فتسابق الناس إلى تزويد المكتبة بالكتب المهمة وإهدائها رسائل الماجستير والدكتوراه، كما أوصى بعض عليّة القوم إبان إنشائها بنقل محتويات مكتباتهم إليها حتى يساهموا بإغنائها، ولكن شهرتها اعتمدت على وجود المخطوطات القديمة والنادرة التي يرجع إليها الباحثون في الدين واللغة العربية على وجه الخصوص فيقصدونها من كل حدب وصوب.
ولا يمكننا هنا إلا المرور على جامعة القاهرة بمكتباتها الواسعة والغنية، والتي اكتسبت شهرتها بصفتها مؤشراً على بداية عصر جديد، حيث أنشئت في عهد محمد على، بعد سنوات قليلة من حملة نابليون على مصر، التي شكلت صدمة حضارية للمصريين والعرب عموماً، فكان تأسيس الجامعة ردة فعل جريئة حاولت دفع مصر للحاق بالنهضة الأوروبية ونجحت إلى حد معقول، تزامناً مع ظهور حركة النهضة العربية عموماً، فكان افتتاح أول كلياتها عام 1820 تحت اسم «المهندسخانة»، لتتطور فيما بعد وتتوسع إلى جميع الاختصاصات وتبقى –قرابة قرن ونصف– رافداً للثقافة العربية بشخصيات بارزة من خريجيها، كان منهم مؤلفين وعلماء ورؤساء دول، وأصحاب جائزة نوبل مثل نجيب محفوظ ومحمد البرادعي.
لقد استطاعت مصر منذ فجر تاريخها تزويد الإنسانية بأسماء مؤثرة، فمنذ عصر البطالمة ظهر اقليدس عالم الرياضيات اليوناني الذي درس في الإسكندرية، وفي العصر الحديث ومن جامعة الإسكندرية تخرج أحمد زويل الذي حصل على جائزة نوبل للكيمياء، كما كان الشيخ محمد عبده الذي ذكرناه سابقاً تلميذاً لجمال الدين الأفغاني الذي يعتبره بعض المؤرخين رائداً من رواد النهضة العربية، وقاسم أمين رائد تحرير المرأة في العالم العربي والإسلامي.
إلا أن هذا الوشاح المزخرف من الأسماء اللامعة والذي لبسته مصر لبضعة آلاف سنة، يفقد كثيراً من بريقه تدريجياً منذ أواخر القرن الماضي، ويخسر الجانب العصري الحداثي الذي لطالما رافق الجانب الحضاري العريق لكل المؤسسات المعرفية المصرية. مع أن القيادة المصرية تعمل اليوم جاهدة على إعادة تظهير صورة مصر كمصدر إشعاع حضاري معرفي، وذلك عبر مشاريع فكرية تعليمية كان أشهرها مؤخراً افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة بالقرب من موقع المكتبة القديمة، والتي تمثل اليوم علامة فكرية وعلمية فارقة، ستسهم مستقبلاً في إعادة الجامعات المصرية إلى سابق عهدها.
لقد رسمت مكتبات مصر من بطليموس إلى الحاج مدبولي تاريخاً زاخراً من التقدم المعرفي، ولا بد لجامعاتها اليوم أن تكون على المستوى ذاته، فترسم مستقبلاً من الحداثة والتطور لمصر، يناسب عظمتها وعراقتها، وريادتها المعرفية التي كانت في الماضي.. ويجب ان تستعاد في المستقبل.